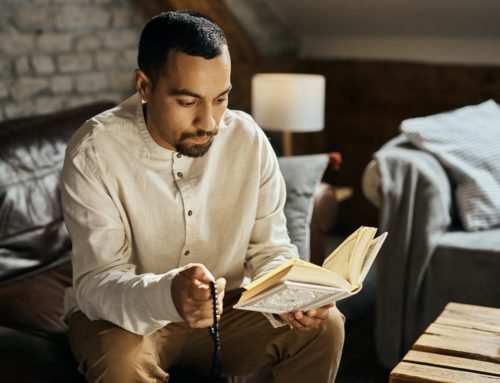سنن الله في كونه لا تتبدل ولا تتخلف فالثبات طابعها، والاستمرارية دأبها، ولذا فإن تعامل البشر مع هذه السنن والنواميس قائم على أن المقدمات تؤدي إلى النتائج، وأن الأسباب مبنية على المسببات، فالماء يغلي إن ارتفعت درجة حرارته إلى مقدار مئوي معلوم، والزرع ينمو إن تعهدته بالسقي والرعاية، والجسم يمرض إن تركته عرضة للجراثيم، ولم تحافظ عليه من الجوع والحر والبرد.
ولا أحد يرتاب في هذه الأشياء لأنها مسلمات يشهد بها الواقع، ويقرها العقل، ويراها الناس أمامهم كل حين، (فما في الكون ذرة أو حركة إلا ولها قانون وسنة .. وما من حركة نفسية أو اجتماعية، أو نقلة حضارية إلا ولها قانون يتجلى في الأسباب والعوامل المؤدية إليها) (سنن القرآن في قيام الحضارات وسقوطها – ص15 – للأستاذ محمد هيشور)
وتخلف الأمم وانهيار عمرانها لا يأتي من فراغ، ولا يتم فجأة، لأن مقدمات هذا الانهيار والانحدار تظل واضحة بارزة أمام الناس عقودا، وربما قرونا من السنين، فإن امتدت إليها يد الإصلاح استقام حال الأمة، وإن ظل الخلل جاريا، والفساد ساريا، انهار البناء الحضاري، وتأخر ركب الأمة في مسيرة الحياة، وسبقها غيرها ممن أخذ بسنن الله في كونه، وعرف كيف يتعامل مع هذه السنن، وهذه قاعدة لا تتخلف مع الأمم، ولا تتخلف كذلك مع الأفراد، فمن أهمل من الأفراد جنى ثمرة إهماله –بعد حين- حسرة، ومن عصى وخاض في الذنوب والآثام جنى نتيجة عمله حرجا في الصدر وضيقا في الرزق، وتعثرا في الحياة، وتكالبا من الأعداء عليه، وانقضاضا من الأعوان عنه، وبالجملة فإن “له معيشة ضنكا“ قبل أن يحشر أعمى يوم القيامة بما جنت يداه، وما حاد به عن منهج الله “ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون“ (الروم: 41)
إن السنن الشرعية التي يلتزم بها الناس من أهم عوامل مقاومة التحلل والفساد، إذ التحلل لا يصيب العمران إلا إذا تعمق في نفوس الأفراد بعد أن تستمرئ الملذات، وتركن إلى الشهوات، وتستلذ حياة الرخاوة والدعة، ولو تحققت على حساب الرجولة والكرامة، حينئذ تستسلم هذه النفوس لخدر الكسل، وطويل الكرى، فتنشط جراثيم التحلل والفساد، وتظهر في المجتمع علامات التخلف والكساد، وقد يطول ذلك فيقضي على الأمة، فتصبح أثرا بعد عين، حدث ذلك مع حضارة اليونان، والرومان، والفرس، وغيرها من الحضارات القديمة، وحدث مع الأندلس الإسلامية حين انشغل الناس بالترف، وتفرقوا مزقا مبعثرة، وأشلاء مبددة، سميت بـ “ملوك الطوائف”، وصار كل (ملك) من هؤلاء طيعا للنصارى، يحارب غيره من المسلمين، ولا يرغب فيهم إلا ولا ذمة، مما جعل النصارى يؤججون نيران الخلاف، حتى إذا أحرق بعضهم بعضا بهذه النيران، سهل عليهم أن يجتاحوا تلك الممالك واحدة بعد الأخرى، فلم يراع هؤلاء السنن الشرعية التي تثبت أن في الترف هلاكا للأمم، لأنها تحيد عن منهج الله، “وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا“ (الإسراء: 16)، ولم يراعوا السنن الشرعية التي ربطت القوة بالتعاون والتآلف “ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم“ (الأنفال: 46)، والسنن الكونية في هذا ليست مخالفة للسنن الشرعية، بل تسير في ركابها، وتثبت مدلولها، غير أن أهل الأندلس خالفوا ذلك فذهبت ريحهم، وذهبت أرضهم وبلادهم، واستبدل الله بهم آخرين، وإن كانوا كافرين، ومع هذا فإن العبرة تكاد تضيع، ولولا أن الله سبحانه يقيض لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها، وبالتالي أمر دنياها، لحدث لها ما حدث للأمم الخوالي، ولنخر فيها ما ينخر الجثث البوالي.
ولئن كانت الأمة الإسلامية لم يصبها الاندثار فقد أصابها الانحدار، فهوت من القمة إلى السفح، لا لأنها لم تأخذ بسنن الله الكونية فقط، بل لأنها –كذلك- حادت عن السنن الشرعية.
ولسوف تبقى هكذا ما لم تعد للأخذ بالسنن الكونية والشرعية، وهما يتحققان بإشاعة مناخ علمي، وبث التربية الدينية، وهما معا ما عمل المسلمون الأولون على إشاعتهما ونشرهما في مجتمع المسلمين، ليكونا ركيزة بناء الأفراد وعمران المجتمعات بناء على الأخذ بسنن الله الجارية في الأنفس والآفاق، وحين يحدث خلل في هاتين الركيزتين تكون النتيجة الحتمية التخلف ثم الجمود والهمود.
ولقد كانت هذه الحقائق واضحة كل الوضوح أمام المسلمين الأولين، مما جعل الحسن البصري يعبر عن هذه السنن بقوله: “إذا وجدت تعثرا فابحث عن خلل في التعامل مع السنن الشرعية، أو السنن الكونية أو كليهما”.
ونحن –الآن- أحوج ما نكون لسد الثغرات، وملء الفجوات، لا للبحث عن الخلل، فقد كان الخلل في زمن الحسن البصري والدولة في قوتها، وتتمتع بفتوتها، وتعمل على اكتمال أسباب نهضتها، أما الآن فإن القضاء على الإهمال ومعرفة السنن والأخذ بها من أهم أسباب البقاء، فلا حياة لمتوان كسول، ولا لمتبلد جهول، ولا لغافل عن سنن الله في الكون والشرع والحياة.